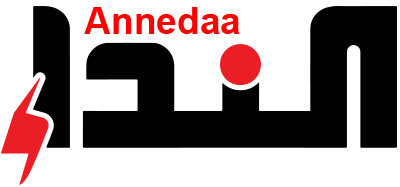منذ سنوات، كنت طالبة في جامعة تونس، حيث كان الحجاب أكثر من مجرد قطعة قماش على الرأس؛ كان تحديًا، معركة يومية ضد نظرات المجتمع وضغوطه. في ذلك الوقت، كانت الحكايات عن محجبات قُوبلنَ بالرفض والعزل، وكان الحجاب مصدرًا للسخرية أكثر منه رمزًا للتدين أو القيم. لكن، لم يكن هذا ليؤثر عليّ. كنتُ مقتنعة بأن الطريق إلى النجاح يبدأ بالتحدي، وأن العلم هو الطريق الوحيد للخلاص من القيود التي تفرضها التقاليد أو الظروف.
أكتب هذه الكلمات اليوم في ذكرى مضت منذ سنوات محملة بالألم والدموع والفرح أيضًا. أكتب عن تلك الأيام التي كانت بالنسبة لي صراعًا بين هوية ترفض الانصياع لغير إرادتي، وحلم لا يفارقني: أن أكون شخصًا متفوقًا في مجالي، بعيدًا عن أنماط السخرية أو العزل الاجتماعي. أريد أن أشارك هذه القصة لأنني أؤمن أن تجاربنا الشخصية ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي دروس نتعلم منها كيف نصمد في وجه التحديات.
أبدأ أولى صفحات هذه الرحلة من الرابعة عشرة من عمري، قبل حوالي عشرين عامًا. كنت مولعة بالمطالعة، بل كانت القراءة والموسيقى الملاذين الوحيدين لعالمي الداخلي. أهرب إليهما من صخب العالم حولي، أغوص في الروايات حتى أعيشها كأنها عالمي الحقيقي، عالم ورديٌّ لا مكان فيه للسخرية أو القسوة.
في إحدى حصص اللغة العربية، كان الدرس عن قصيدة "قارئة الفنجان". حفظت كلماتها عن ظهر قلب، وتعلقتُ بها تعلق العاشق بمعشوقه. انتظرت تلك الحصة بفارغ الصبر، ليس فقط لأقرأ القصيدة، بل لأُلقيها بصوتٍ معبّر، يخرج من أعماقي. تطوعت للإلقاء، وكان لي ما أردت، فألقيتها من قلبي، وعشت كل بيت من أبياتها.
لكن ما واجهني لم يكن إعجابًا، بل ضحكًا هستيريًّا، مستهزئًا، وصاخبًا، من زملائي في الصف. لم يكترث أحد لجديتي، ولا لانغماسي في النص. وحده الأستاذ شكرني، محاولًا كتم ضحكاته. حين انتهت الحصة، انتشر الخبر في الساحة، وصار الجميع يبحث عني لإكمال لحظات السخرية. أما أنا، فوقفت "كالجبل لا تهزه الرياح"، ضحكت معهم رغم المرارة، وقررت أن أغلق باب حواسي على العالم. صنعت لي قوقعة عشت داخلها، أتمسك بحلاوة الأدب، وإن كان لا يدركها إلا القليل.
مرت السنوات، وبلغت مرحلة اختيار التوجيه. كنت أحب الأدب؛ لكن ميلي للرياضيات والعلوم جعلني أفكر في الشُّعب العلمية. استشرت أستاذ الرياضيات، وسألته إن كانت شعبة الرياضيات مناسبة لي. رغم أن أرقامي كانت طيبة، أجابني بأنها لا تناسبني، وأن النجاح فيها سيكون صعبًا. لا أعلم حتى الآن سبب رأيه ذاك؛ أهو محبط بطبعه؟ أم أنه رأى فيّ شيئًا لم أره؟! ربما لأنه لو خُيّر ثانية لاختار طريقًا آخر غير الرياضيات! لا أدري!
لكن كلماته لم تكسرني؛ بل على العكس، أيقظت فيّ روح التحدي والعناد، فاخترت شعبة الرياضيات، كأنني أردت أن أثبت لنفسي قبله أنني أستطيع.
عام البكالوريا كان استثنائيًا، حافلًا بالتحديات التي حفرت في ذاكرتي مسارات لا تُنسى. أتذكر أستاذ الفيزياء جيدًا؛ كان يُملي الدروس ثم يفسرها لاحقًا، وكأن الفهم أمر ثانوي يأتي بعد الحفظ. هذه الطريقة كانت تستفزني؛ كيف يُطلب مني أن أكتب شيئًا لا أفهمه؟! كيف أتابع دون أن أُمسك بالخيط الأول؟!
في أحد الأيام، قررت ألا أكتب حرفًا. جلست في مكاني ساكنة، أرفض أن أنقل ما لا يدخل عقلي. لم يتأخر الأستاذ في ملاحظتي. أمرني بالكتابة، فأجبته بهدوء: "لن أكتب ما لا أفهم". فتحتُ بهذا الرد، دون أن أعلم، أبواب جهنم. انهالت عليّ الشتائم، وطُردت من القسم، ظلمًا، فقط لأنني عبّرت عن حقي في الفهم.
بعد ذلك، لجأت إلى حيلة الصمت. صرت أجلس في آخر الصف، أتظاهر بالكتابة، أراقب بصمت، لا أتكلم. ورغم كل شيء، كنت عاشقة للدراسة، لا أطيق فكرة الجهل. قررت أن أعتمد على نفسي. أمسكت كتاب الفيزياء، الذي بالكاد كنا نرجع إليه في القسم، وانكببت عليه أقرأ، وأحلّ التمارين، وأعيد الإصلاحات حتى أفهم. دفعتُ ثمن عنادي هذا مجهودًا مضاعفًا؛ لكنني لم أندم.
ذلك العام كان أيضًا مختلفًا لأني اخترت ارتداء الحجاب. لم يكن خيارًا مفروضًا، بل نابعًا من قناعة داخلية خالصة. غير أن قراري هذا لم يرق للكثيرين. أحد أقاربي وصفني ساخرًا بـ"الإخوانجية". مزاح ثقيل لم يرق لي. كثيرون حولي تساءلوا كيف سأجتاز امتحان الرياضة بالحجاب؛ ماذا سأرتدي؟ أزعجتني تلك الأسئلة؛ وكأنني اخترت دربًا مستحيلًا. لكني كنت ثابتة على موقفي، لا أنتظر موافقة أحد، ولا أُخضع حريتي لأي إملاءات خارجية.
وعندما جاءت نتائج البكالوريا، جاء النصر صريحًا:
• 17 في الرياضيات.
• 15 في الفيزياء.
• 17.5 في العلوم.
• 18.3 في الرياضة.
يومها، ضحكت من قلبي، وقلت في دخيلتي: "ربحتُ الرهان".
إلا أن الرهان الأكبر لما يكن بدأ بعد؛ فمرحلة التوجيه الجامعي كانت قادمة، ومعها سؤال أصعب:
أية مدينة سأختار؟ وكيف سأتعايش مع واقع أن تكون فتاة محجبة في قلب العاصمة؟!
كان قرار الدراسة في العاصمة أحد أكثر قراراتي جرأة. كنت أعلم جيدًا أن الضغط على المحجبات هناك لا يُطاق. رغم ذلك، اخترت مواجهة هذا التحدي، مدفوعة بحلمي وتشبثي بحريتي. حين حاول والدي أن ينبهني، قائلًا: "راك باش تتعبي"، وقالت أمي: "انزعيه وإلا سنبقى قلقين عليك"، لم يُضعفا عزيمتي، بل غذّى كلامهما شعلة الإصرار داخلي.
اخترت شعبة المرحلة التحضيرية في تونس العاصمة، وأنا ابنة الجنوب البسيط، بثقافتي ولهجتي ونمط عيشي المختلف. من أول يوم في الجامعة، أدركت أن ما سأعيشه ليس مجرد تجربة تعليمية، بل هو معركة بقاء.
كل شيء كان صعبًا: الدروس، المسافات الطويلة، وسائل النقل المكتظة، وبُعد السكن عن الجامعة. أما الأصعب من كل هذا فهو الحجاب. لم يكن ممنوعًا في القاعات فقط، بل حتى في السكن والمطعم الجامعيين. كنت أتنكر لأدخل؛ أرتدي قبعة ووشاحًا لأغطي شعري. بدا مظهري غريبًا في البداية، حتى إن زملائي لم يفهموا السبب.
لكن حتى تلك القبعة لم تسلم من الرفض. كان الحارس عند باب المعهد يُصر على نزعها. في البداية كنت أخلعها عند الباب ثم أرتديها بعيدًا عن أنظاره، حتى صار ذلك طقسًا يوميًا؛ إلى أن جاء اليوم الذي باغتني فيه من الخلف! انتزع قبعتي بعنف، وانهال عليّ بالسباب والشتائم أمام أعين الطلبة. وقفت مذهولة، والدموع تغالبني، لا من الإهانة فقط، بل من شعور بالظلم قاسٍ لا يُوصف.
في اليوم التالي، اتخذت قرارًا غريبًا؛ لكنه كان بالنسبة لي انتصارًا صغيرًا: لن أدخل الجامعة من بابها بعد اليوم.
وجدت فتحة ضيقة بين الأعمدة الحديدية التي تُسيّج الجدار، وبدأت أمرّ من خلالها يوميًا. كنت أدخل الجامعة خلسة... من أجل طلب العلم.
يا لسخرية القدر! طالبة تتسلل إلى مدرجات الدراسة كأنها تُقدِم على جريمة!
في القسم، شعرتُ دومًا بأنني "الغريبة". هندامي ولهجتي الجنوبية، وصمتي، كلها كانت تضعني في خانة "الاستثناء". كنت بطيئة في الكتابة، لا أستطيع أن أكتب وأفهم في الوقت ذاته. كنت بحاجة إلى وقت مضاعف، وتركيز مضاعف، لا أملكهما وسط هذا الصخب.
لم يكن هناك دعم يُذكر. كنت أجوب المكتبات ومحال الطباعة بحثًا عن دروس قد تكون من البرنامج، أو لا تكون، فقط لأمنح نفسي فرصة للفهم والمراجعة. كنت أراجع بلا خريطة، أمسك بأي خيط وأتعلق به، على أمل أن يقودني إلى فهم ما.
انتهى العام الأول، ورجعت إلى عائلتي لا أعلم إن كنت ناجحة أم لا. وذات يوم صيفي، حضر ساعي البريد إلى بيتنا باحثًا عني. حمل برقية، ورفض إخبار والدي بمضمونها. ظننتها استدعاءً للطرد أو تحذيرًا بسبب حجابي. خفت أن تُكشف معاناتي. رفض والدي أن أذهب بمفردي، ورافقني على دراجته النارية إلى مكتب البريد.
دخلنا إلى المكتب، وقدماي ترتجفان من الخوف. سلّمني الموظف البرقية، ثم هنأ والدي قائلًا:
"ابنتك الأولى في دفعتها".
قرأت الرسالة مرارًا! لا أصدق! شعرتُ بنشوة الانتصار، ممزوجة بدموع أبي التي كانت تلمع في عينيه؛ ليست الدموع... بل الفخر.
لكن، لم يكن بمقدورنا الذهاب إلى الحفل. تكاليف السفر والمبيت كانت أكبر من إمكانياتنا. قلت لوالدي:
"سآخذ جائزتي مع بداية العام القادم"، وهكذا كان.
حين عدت، دخلت مكتب العميد بقبعتي ووشاحي، وطلبت جائزتي. نظر إليّ من رأسي حتى قدمي، ثم قال:
"لن أعطيك الجائزة... تعلمين لماذا".
انفجرت باكية، بكاء عجز، وألم، وظلم. لم أستطع الرد، وكأن لساني انعقد. حين رأى دموعي، رقّ قلبه، وربما شعر بثقل ما قاله، فقال معتذرًا:
"ما تبكيش يا بنتي... باش نعطيك الجائزة. قلت هكاك خاطي الحجاب ممنوع... والأمن الجامعي هو اللي يفرض".
خرجت بالجائزة في يدي، وجرح في صدري. لم تكن فرحتي كاملة. كانت جائزة "مسمومة"، كشفت ضعفي وهشاشتي، رغم أني قضيت عامًا كاملًا أتقمص دور القوية التي لا تُقهر.
كان المبيت الجامعي "شوقي" أقرب إلى معسكر صمود منه إلى سكن طلابي. جدرانه تقبض الروح، وقوانينه تكبل أبسط الحقوق؛ لكن داخله، كانت تتخلق أجمل الصداقات وأكثر الذكريات حميمية.
لم يكن مجهزًا بمطبخ، بل كان الطبخ ممنوعًا منعًا باتًا. ومع ذلك، كنا نكسر هذا المنع يوميًا؛ لأن المطعم الجامعي، بصراحة، لم يكن يقدم طعامًا يمكن وصفه بـ"البشري". أقرب ما يكون إلى علف يسكت صرير المعدة فحسب. ثمن التذكرة؟ 200 مليم... مبلغ زهيد، لكنه يحمل تأثيرًا عجيبًا: يُخدّر الجسد بالكامل؛ كأن في الطعام "كربونات" منومة، لا محالة تجرنا إلى النوم الثقيل بعد الأكل.
لكن كنا نعرف الحل: قهوة مركّزة، والمزيد من الضحك.
مع حلول منتصف الليل، تبدأ الحياة الحقيقية. دبكات خفيفة في الممرات تُعلن رفع حظر التجوال الداخلي. البطون الخاوية تطالب بحقوقها، فنخرج كنوزنا الصغيرة: معلبات، خبزًا يابسًا، جبنًا، بسيسة، هريسة، "ريزستانس" مخبّأ بعناية كعنوان للمقاومة... نمد "سفرة الأرض"، ونجلس كأننا في وليمة النصر.
وخلال الأكل، يبدأ مهرجان الضحك: لهجات مختلفة، نُكت، مواقف، ذكريات، من الجنوب والشمال والوسط، خليط مدهش من الثقافات. كم أحببت تلك اللحظات! رغم القسوة، كنا نخلق متعة خاصة، طاقة شحن نفسية لا تُوصف.
تعرفت هناك على صديقات من كل الجهات:
• "وفاء" و"إخلاص" من نفطة.
• "سمية" من بئر الأحمر.
• "نوال" من ساقية سيدي يوسف.
• "وداد"، "وفاء"، "حذام"، من ماجل بلعباس.
• "ريم" من نابل...
وغيرهن كثيرات تركن في القلب بصمة.
حتى "الدوّاش" (غرف الاستحمام) كانت نادرة. تفتح مرتين في الأسبوع، ونصفها معطّل. من استطاعت الظفر بـ"دوش"، كانت كمن نالت جائزة كبرى! أحيانًا تنشب معارك صغيرة على من يدخل أولًا. تضامن رفيقات الطابق كان يسندني، فأتحصل على دوري.
المضحك أن هذا الضيق كان سببًا في أقوى الذكريات. في لحظة فوضى داخلية، كنت أخرج ليلًا وأدور في المبيت أراجع بصوتٍ عالٍ، محاوِلةً حفر الدروس في الذاكرة. حجم المعلومات هائل، والكلمات التقنية لا تُفهم، بل تُلقّن وتُحفظ كأنها طلاسم. لكنني كنت أحاول دوماً، وأقول لنفسي: "المحاولة وحدها لا تكفي، لكن الاستسلام مرفوض".
كنت أتفوّق في الرياضيات والفيزياء، وغالبًا ما أحصل على العلامة الكاملة. أذكر جيدًا حصولي على 20/20 في كلتا المادتين في أحد الفروض، وكان هذا يدفعني للأمام رغم العوائق.
وفي أحد الأيام، كنت في الصف الأول، أستعد للمناظرة، حين أُغمي على زميلة لي فجأة. تطوعت لأرافقها إلى المستشفى. لم أكن أغادر القسم عادة؛ لأنني أستغل كل دقيقة للفهم. لكن تلك المرة خرجت. ولعب القدر لعبته: التمارين التي شرحها الأستاذ في غيابي، هي نفسها التي وردت في المناظرة!
ورغم ذلك، نجحت.
اخترت بعد ذلك الالتحاق بمعهد العلوم الفلاحية. لم يكن خياري المثالي، لكن بقية التخصصات إما لم تهمني، وإما كانت جامعاتها أكثر تضييقًا على المحجبات.
دخولي إلى معهد العلوم الفلاحية لم يكن حلمًا، بل كان أشبه بالهروب من واقع أكثر قسوة. لم أحب هذا التخصص؛ لكن بدا لي أقل وطأة من الخيارات الأخرى، حيث كان التضييق على المحجبات أشد وأكثر عنفًا.
من أول يوم، شعرت بأنني في المكان الخطأ. حينما كنت أدخل درس "الميكانيكا الفلاحي" كنت أخرج محطمة نفسيًا. ما علاقة هذا المجال الصعب بالأمل الذي بنيته؟! أعود إلى غرفتي، أغلق الباب، وأبكي لساعات. لا أفهم شيئًا، ولا أستطيع أن أحب المواد، ولا أملك أي دافع للمراجعة. كنت أتهرب من الكتب وكأنها أعداء، ويمر الوقت ثقيلًا، خانقًا.
اقترب موعد الامتحانات وأنا لم أراجع شيئًا. كرهت كل ما حولي. كنت في مفترق طرق: إما أن أستسلم وأفشل، وإما أن أواجه الأمر كما اعتدت دائمًا.
وفي لحظة عزيمة، قلت لنفسي:
"لا بد أن أنجح، بل أن أنجح بامتياز".
أغلقت عليّ غرفتي، وبدأت المراجعة المكثفة. يومًا بيوم، مادة بمادة، كنت ألتهم الدروس، أراجع ستة أشهر من المحاضرات في يوم وليلة، ثم أذهب في الصباح لأجتاز الامتحان، وأعود مساءً لأبدأ مع مادة أخرى.
تزامنت تلك الفترة مع شهر رمضان، ولم يكن لديّ وقت للطبخ، فكنت أذهب إلى المطعم الجامعي. أذكر جيدًا ذلك اليوم الذي وقفت فيه مع صديقتي ننتظر الإفطار. أذّن المؤذن، وأملنا معلق على لقمة تسكت الجوع. فجأة، دخلت مديرة المطعم، وصرخت:
"المحجبات برّا! ما تاكلوش!".
طردتنا من الصف، فقط لأننا كنا محجبات. خرجنا مذهولتين، والطرقات مغلقة، والدكاكين مغلقة. لم يكن أمامنا إلا قليل من البسيسة والماء. تقاسمناها، وضحكنا من المرارة، وقلنا لبعضنا:
"ما يدوم حال".
رغم كل هذا، نجحت، وكنت الأولى في الدفعة. اخترت بعدها شعبة علم النباتات، لأجد فيها أخيرًا جزءًا من ذاتي. هذا الكائن الصامت، الصبور، الذي ينمو رغم كل شيء… وجدته يُشبهني. يُقاوم بلا صوت، يمد جذوره في الأعماق، ويواصل النمو حتى لو ضاق عليه الوعاء.
في نهاية المرحلة، حصلت على شهادة الهندسة بتفوق، وفتحت أمامي فرصة إكمال الدراسات العليا. كان عليّ أن أختار: فرنسا، أو إسبانيا!
اخترت فرنسا. ركبت الطائرة، أودّع وطني ودمعة تسقط من عيني بصمت، غير قابلة للتفسير!
"كم أحبك يا بلادي! متى تنصلح الأحوال وتعود البسمة والمحبة والتسامح؟!".
وصلتُ إلى فرنسا، أجرّ خلفي سنوات من التعب، والقهر، والانكسارات الصغيرة التي لم تنجح أبدًا في كسر إرادتي. حملت معي كل لحظات الصبر، وكل دمعة خبأتها كي لا تنهار جبهتي، وكل قُبلة فخر طبعها أبي على جبيني، وكل ضحكة من صديقات المبيت كانت تسندني في خريف الاغتراب الداخلي...
هناك، بعيدًا عن أرض الوطن، بدأت مرحلة جديدة: الدراسات العليا.
عملت بجهد، لا لأنني فقط أردت النجاح، بل لأنني كنت أُمثل أكثر من نفسي: كنت أُمثل الفتاة المحجبة التي دخلت الجامعة خلسة من بين القضبان الحديدية، وأُمثل الطالبة التي طُردت من المطعم في رمضان، وأُمثل صوت بنات الجنوب اللواتي كان يُنظر إليهن باستعلاء بسبب لهجتهن وهندامهن...
اجتزت مرحلة الماجستير في البحث، ثم انتقلت إلى مرحلة الدكتوراه، إذ ازداد العمل صعوبة؛ لكنني كنت مستعدة. عزيمتي كانت تشكلت في فرن التجربة، وما عدت أهاب نارًا.
نعم، بفضل الله، ثم بالصبر والعمل الدؤوب، حصلت على:
- شهادة المهندس.
- شهادة الماجستير في البحوث.
- شهادة الدكتوراه.
كل شهادة منها كانت وثيقة انتصار، لا على المنظومة فحسب، بل على الشك الذاتي، وعلى كل من قال لي يومًا: "ما تنجمش"، "ما تنجحيش"، "انزعيه"، "ما عندكش مستقبل"...
لكن نجاحك لا تصنعه وحدك.
لا أنسى أهلي، الذين كانوا صخرتي الأولى:
أبي عبدالكريم عبيشو، وأمي مبروكة فريعة، وأخواتي العزيزات بلقيس، إكرام، سيرين، وفاء…
ولا أنسى زوجي، برهان شويخة، الذي ساندني، وقف بجانبي، دفعني للأمام عندما راودني الشك.
ولا أنسى عائلته الكريمة: أخته هند شريف وابنتيها الجميلتين فاطمة وفجرة، وكل عائلة شويخة، التي احتضنتني بمحبة.
وأحبتي من الأصدقاء الذين صاروا عائلتي الثانية:
فرج جبيرة، راضية، مريم، مريومة... وغيرهم كُثر، كل واحد منهم ترك في روحي بصمة لا تُنسى.
وأخيرًا، قصتي ليست عن الحجاب فقط، بل عن الحرية، عن الكرامة، عن كسر التوقعات، عن تحويل الضعف الظاهري إلى قوة داخلية لا تُقهر.
ربما بكيت كثيرًا؛ لكني لم أضعف. ربما تعبت؛ لكنني لم أتنازل. وربما سقطت؛ لكنني دائمًا ما نهضتُ واقفة.
هذه ليست النهاية، بل بداية لحياة أردت دائمًا أن تكون شهادة حية على أن: "الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع. والعلم لا يُطلب مرفّهًا، بل يُنتزع انتزاعًا... والكرامة لا تُطلب، بل تُصان بالصبر والإصرار".
إلى كل فتاة تُجاهد لتثبت نفسها، إلى كل طالب يحمل على كتفيه عبء القهر، إلى كل من يحاول أن يبني رغم الخراب:
أنت لست وحدك. صبرك اليوم، سيصير غدًا قصة تُروى، فاثبُت.