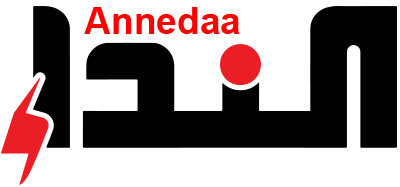في زوايا كثيرة من وطننا اليمني، يجلس شابٌّ يُفكّر:
هل أملك القدرة على إحداث فرق؟
هل يمكن لصوتي أن يُسمع، لفكرتي أن تُثمر، لخطوتي أن تُلهم؟
في قلب كل شاب يمني حلمٌ... وفي قلب الحلم نارٌ تنتظر أن تجد مسارًا لا تحرق فيه، بل تُضيء.
لكن الطريق من الحلم إلى الفعل ليس معبّدًا دائمًا.
هناك إحباط، وفقر، وبطالة، وأحيانًا مجتمع ينظر إلى الشباب كمراهقين يجب تأديبهم، لا كمبدعين يجب دعمهم.
ومع ذلك، ورغم العثرات، ورغم الأصوات التي تُشكك، ينطلق البعض من الشباب، من أحياء بسيطة، من قرى نائية، من أماكن ظنّها الناس نائمة، ليُثبتوا أن التغيير لا يحتاج إذنًا من أحد.
يبدؤون بمبادرة صغيرة: حلقة قراءة، مشروع نظافة، ورشة توعية، أو درس مجاني للأطفال... ثم يكبر الأثر شيئًا فشيئًا، ويتحوّل الصدى إلى عمل ملموس، والعمل إلى ثقافة متجذرة في الوعي الجمعي للمجتمع.
حين يتوحّد الشباب على خدمة مجتمعهم، يصبحون الرابط الذي يوحّد القلوب، والنبض الذي يُحرّك الكبير قبل الصغير.
هؤلاء ليسوا أبطالًا خارقين، بل شبابٌ عاديون مثلنا، لكنهم صدّقوا أن بإمكانهم أن يفعلوا شيئًا. آمنوا أن التغيير لا يبدأ من فوق، بل من داخل الأحياء، ومن داخل أنفسهم.
هنا، في اليمن، نحن أحوج ما نكون إلى هذا النمط الجديد من الفعل:
فعلٌ لا ينتظر التمويل، ولا الإعلام، ولا المناصب، بل يعتمد على المبادرة، وعلى الإيمان بأننا لسنا مجرد متفرجين على واقعنا، بل صنّاع له.
وهكذا، بدلًا من أن يكون الشباب مجرد صدى يتلاشى في الزوايا المنسية، يصبحون نبضًا في قلب المجتمع.
يتحوّلون من متلقين إلى مبادرين، ومن ضحايا الواقع إلى مهندسيه.
في كل حارة، في كل مدرسة، في كل قرية، هناك فرصة لمشروع صغير يحمل بذور مجتمع جديد.
فهل نمنح الشباب المساحة ليجربوا؟ وهل نحتضن أخطاءهم كما نحتفي بنجاحاتهم؟ وهل نقف معهم لا أمامهم؟
ربما، إن فعلنا ذلك، نكون قد ساعدنا الحلم أن يمشي... لا أن يبقى معلقًا في سقف الأماني.