وثيقة جديدة للمشترك تشدِّد على أولوية القضية الجنوبية
نص الوثيقة:
* الإطار السياسي لرؤيةاللقاء المشترك لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة
* القضية الجنوبية يجب أن تكون من الأولويات التي يتم الحوار حولها بإشراك القوى الفاعلة في الحراك السياسي، مع أهمية وقف المطاردات والملاحقات للنشطاء السياسيين وتقديم من قاموا بالاعتداءات والقتل للمتظاهرين إلى العدالة
* إن جذر الأزمة يكمن في نظام سياسي وصل بالبلاد إلى مأزق لم يعد معه قادراً على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل البلاد الوطنية والسياسية
* لابد أن يكون الحوثيون طرفاً في حوار وطني شامل من منطلق ما رتبته الوقائع من حقائق على الأرض
 كان موقف أحزاب اللقاء المشترك صائباً ومسؤولاً حينما أكد في سياق رؤيته لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على ضرورة توفير المناخات السياسية الملائمة، فمثل هذه الانتخابات لا يمكن أن تتم إلاّ في ظل مناخات سياسية واجتماعية توفر شروط المنافسة الحقيقية بعيداً عن التوترات والاضطرابات وأجواء الصراع الناجمة عن تلاحق الأزمات واشتداد ضغوطها وتأثيرها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية.
كان موقف أحزاب اللقاء المشترك صائباً ومسؤولاً حينما أكد في سياق رؤيته لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على ضرورة توفير المناخات السياسية الملائمة، فمثل هذه الانتخابات لا يمكن أن تتم إلاّ في ظل مناخات سياسية واجتماعية توفر شروط المنافسة الحقيقية بعيداً عن التوترات والاضطرابات وأجواء الصراع الناجمة عن تلاحق الأزمات واشتداد ضغوطها وتأثيرها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية.
المناخ السياسي والأنتخابات:
ويعكس الحديث عن المناخات السياسية الملائمة حرص المشترك على أن تؤدي الانتخابات النيابية وظيفتها الحقيقية في وضع البلاد على المسار الذي يفضي به إلى الإستقرار والتقدم وتعزيز وحدته الوطنية والسياسية وتوفير الشروط المناسبة لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في تحسين معيشة الشعب. وتفاعل كل هذا مع العوامل الضرورية التي ستولدها هذه الظروف لإنتاج الحكم الرشيد الذي لا يمكن التفكير في مستقبل اليمن بدونه، ونقصد بالحكم الرشيد ذلك الحكم الذي يستند على دولة شراكة ومواطنة ذات نظام مؤسسي ديمقراطي لامركزي يتم فيه تداول السلطة سلمياً عبر انتخابات حرة ونزيهة؛ أي حكم غير قابل للعودة بالبلاد إلى سيطرة البنى ما دون الوطنية.
وفي ظل الوضع الحالي الذي تتحكم فيه أزمة وطنية عميقة بمظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية يصعب الحديث عن انتخابات تحقق هذا الهدف أو تسهم ولو جزئياً في تحقيقه. فالأزمة بصورة عامة قد استفحلت لدرجة أضحت معها ضاغطة بقوة على الحياة السياسية وشوهت بذلك كل العمليات التي تتم في إطارها بما في ذلك الانتخابات والمشروع الديمقراطي عموماً.
جذر الأزمة:
إن جذر الأزمة يكمن في نظام سياسي وصل بالبلاد إلى مأزق لم يعد معه قادراً على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل البلاد الوطنية والسياسية والاقتصادية. فمن ناحية استهلك النظام كل أدواته التقليدية في تسيير شؤون البلاد دون أن يدرك أن الحياة قد دفعت بمشاكل جديدة ومختلفة إلى السطح لم تعد تجدي معها الأدوات التي أخذت تستنزف كل جهد وطني، بل وتراكم مزيداً من الأزمات والمشكلات الاضافية أمام الوطن، الأمر الذي بات يهدد البلاد بمصاعب بنيوية من النوع الذي يؤدي إلى أخطار حقيقية تهدد وحدته وسلامته.
كل ذلك والنظام لازال يتمسك بنفس أدواته التقليدية في المناورة واستهلاك الديمقراطية والسعي نحو ترتيبات تجعل الخيار الديمقراطي التعددي خياراً مستحيلاً، مع عدم قدرته على خلق الشروط المناسبة للوحدة التي من شأنها حماية البلاد من التفكك السياسي والعرقي والطائفي، ناهيك عن فتح الباب بلا قيود أمام الانقسامات الاجتماعية من خلال غياب السياسة الاقتصادية والمالية القادرة على منع سيطرة قلة، من المنتفعين والمحسوبين، على ثروات ودخل البلاد وإفقار المجتمع بصورة لم يعد معها ممكناً البحث عن حلول جزئية في إطار هذه السياسات غير الرشيدة.
إن إصرار النظام وسلطته على التمسك بهذه الأدوات التي عفى عليها الزمن للتعاطي مع قضايا تتعقد كل يوم يضع البلاد أمام تحديات خطيرة لايمكن إغفالها حينما يصبح من الضروري قراءة الأوضاع على نحو موضوعي وبعيداً عن الحسابات السياسية. فلم يعد هناك مجال أو هامش من أي نوع لقراءة هذه الأوضاع بحسابات أخرى غير ما يعرضه الواقع بوضوح من تحديات خطيرة لا تقابلها في نفس الوقت السياسات الحريصة على تجنيب البلاد الانزلاق نحو الكارثة.
غياب الدولة المؤسسية:
وإذا كان جذر الأزمة يكمن في النظام السياسي، فإن أول مظاهره هو غياب الدولة الوطنية المؤسسية، حيث عمد النظام إلى استبدالها بسلطة اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الأخر نحو حماية النظام السياسي والاجتماعي في عمليتين تلتقيان معاً في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة وهي مواصلة تكريس الأدوات التقليدية التي لم يعد هذا النظام قادراً على إنتاج غيرها.
إن هذا التكريس يبطن تعسفاً للصيرورة التي يفرضها التطور العام في صورة نمو الحاجة الوطنية للدولة بسبب التطور في الوعي الاجتماعي وكذلك التأثير المتزايد للتجارب العالمية في القضاء على التخلف والسير في طريق التطور في بلدان ذات ظروف أكثر صعوبة وتعقيداً من اليمن. إن استمراره والإصرار عليه أدى إلى بروز تناقضات عميقة بين النظام السياسي وآلياته وأدواته التقليدية ومنها الحروب كأبرز أدواته التي عصفت بالوحدة السلمية وكرست القوة والعنف من ناحية، والمجتمع وحاجاته من ناحية أخرى. وبدلاً من بحث المشكلة في هذا السياق الحقيقي للمشكلة أخذ النظام يصور المسألة على نحو مختلف على أنها خلاف سياسي مع المشترك، وهي محاولة لتبسيط المشكلة، موظفاً كل آلياته وأدواته لتكريس هذا الفهم وكأن حل المشكلة سياسياً مع المشترك ينهي الأزمة ويعالج جذرها.
وهناك من البراهين مالا يحصى عن أن هذا النوع من التناقضات يولد مزاجاً صدامياً داخل المجتمع يصعب معه وضع الخيار الديمقراطي الهش في صورته التي تسعى السلطة اليمنية إلى فرضه في مواجهة حاجة المجتمع إلى التغيير، حيث يفقد الناس الأمل في الإصلاح أو التغيير بواسطة هذا النوع من الديمقراطية.
إن ما نشاهده اليوم في واقع اليمن هو أن التناقض قد أخذ يشتد وينتج هذا المزاج الصدامي، وبدلاً من أن تقرأة هذه السلطة ونظامها بصورة صحيحة تمكنها من معرفة أسبابه الموضوعية فإنها تواصل مناوراتها بمحاولة تجريد هذا المزاج عن مسبباته الحقيقية، وبالتالي فصل الأزمة عن جذرها، وتتويه البلاد في صخب مفتعل عن «المخاطر» التي تتعرض لها في إشارات واضحة إلى إصرار المشترك ومعه المجتمع على الوقوف أمام الازمة بمسؤولية وعدم تجاوزها إلى انتخابات شكلية تميع الموقف الحاسم لقطاعات واسعة من المجتمع والتي تؤكد على الضرورة الوطنية لجعل الأزمة في صدارة الفعل السياسي بما في ذلك الانتخابات إذا ما أريد لأطراف الحياة السياسية والمجتمع بأكمله أن يتجهوا بجدية نحو إنقاذ البلاد من الكارثة التي تتجه إليها.
إلغاء الشراكة الوطنية:
وإذا كان غياب الدولة الوطنية المؤسسية قد شكل المظهر الأول لمأزق هذا النظام السياسي باعتباره جذر الأزمة، فإن هذا بدوره قد ألغى الشراكة السياسية والوطنية بسبب غياب حاملها الحقيقي وهو الدولة، وبسبب ضرب الوحدة السلمية التي كانت هي القادرة وحدها على الاضطلاع بخلق شروطها. واستبدلت الشراكة بنظام الولاءات، وهو نظام يقوم فيه مركز السلطة بتأسيس قاعدة لمعايير سياسية واجتماعية ومناطقية- جهوية، يتم وفقاً لها بناء الحزام الأمن للنظام، ويحصل منتسبو هذا الحزام على نصيب الأسد من ثروة البلاد ومن المناصب العليا والوظائف الأساسية. وتقوم العلاقة بين مركز السلطة وهذ الحزام الواقي على قاعدة مختلفة لنظام الشراكة الوطني، فهو نوع من الشراكة في السلطة والمصالح، ولا ترى المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء أو الفئات الاجتماعية والسياسية التي جاءوا منها أنها شريكة فعلاً في السلطة، فمن ناحية لا تقوم العلاقة بين مركز السلطة ومنتسبي ذلك الحزام على أساس الشراكة وإنما على أساس الولاء مقابل نصيب معين من الثورة، وبالتالي فإن ولاء هؤلاء لمركز السلطة أقوى من ولائهم للمناطق أو للفئات الاجتماعية والسياسية التي يمثلونها. وقد يقال فيما يعتبر جدلاً عقيماً إن الولاء هنا هو للوطن، والحقيقة هي أن الوطن في مثل هذه الأحوال يتجسد في مركز السلطة إلى درجة لا يمكن لثقافة هذا النوع من الأنظمة أن تفصل بين الوطن ومركز السلطة. ومن هذا المنطلق يتم بناء هذا الولاء على هذا المفهوم المضلل الذي يجعل الولاء للمصلحة الشخصية ولاءً للوطن. من ناحية أخرى فإن غياب النظام المؤسسي الذي يمكن أن تنتظم بواسطته شراكة هؤلاء يجعل العملية مستحيلة حتي ولو أراد هؤلاء من باب الإحراج أن يلعبوا هذا الدور. فهم لم يُختاروا مؤسسياً ليقومون بدور الشريك وإنما جرى تعيينهم مركزياً بناءً على المعايير التي قررها مركز السلطة.
الروابط البنيوية:
لقد عطل نظام الولاءات، هذا، الشراكة السياسية والوطنية، وبالتالي فإن الروابط الوطنية داخل بنية «الدولة» أصبحت من الرخاوة إلى درجة أنها باتت تشكل عقبة حقيقية أمام تعبئة المجتمع لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلد، فالحوافز الوطنية يجري في الأساس تعطيلها بواسطة إنتاج حوافز تخدم الولاء للسلطة وهي ذات طبيعة مختلفة تماماً. فهي ترهق البلد بالتزامات مادية تجر عليه مزيداً من المشاكل ناهيك عن أنها تنشيء قيماً تعمل على تعطيل الحوافز الوطنية حيث تتسع المساحة التي يتم فيها تفسخ الروابط الوطنية واستبدالها بذلك النمط من السلوك الذي يعبر عن القيم الجديدة لنظام الولاء، وهي قيم تخلق ذلك النوع من الروابط الداخلية الرخوة بما يمهد لإشاعة ثقافات تفكيكية بالاستناد إلى عوامل محلية وقبلية وطائفية وعرقية. وهذه الثقافة تسود في ظل هذه الأوضاع رغماً عن مركزية النظام وحِدة سطوته القائمة على القرار المركزي، فالمركزية هنا هي تعبير عن غلو وتطرف في التمسك بنظام الولاء لمركز السلطة، ذلك النظام الذي يصعب عليه أن يخول سلطاته أو يسمح بتوزيعها لمؤسسات أخرى مركزية أو محلية. وهو بهذا لايمتلك مقومات توليد ثقافة وحدوية وطنية، لأنه يوجه هذه المركزية نحو هدف مختلف ذي طابع أمني مرتبط بحاجة سلطته المركزية.
وتسود الثقافة التفكيكية كمكون لوعي المجتمع يكون الانتماء إلى بنى مادون الدولة، مثل القبيلة والطائفة والعرق، أقوى من الانتماء إلى الدولة. والوضع الآن في اليمن هو تعبير عن حالة لا توجد فيها دولة بالمعنى الذي تقدم فيه كعنوان لمؤسسة أكبر من تلك البنى التقليدية، لذلك لابد من النظر إلى هذه المسألة وما يتفرع عنها من فجوات خطيرة في البنيان الوطني على أنها تقف في صدارة القضايا التي يجب التركيز عليها حينما يدور الحديث عن المناخ السياسي، لأن القضية لاترتبط فقط بإصلاحات جزئية تطال النظام الانتخابي وإدارته وإنما التفكير بجدية في حاجة البلد إلى إصلاح جذري للنظام السياسي ومعه إصلاح جذري للنظام الانتخابي يضع السلطة بيد الشعب، ويتجه إلى بناء الدولة المؤسسية الديمقراطية على قاعدة الشراكة الوطنية بنظام لامركزي يقود إلى الشراكة الوطنية الحقيقية في الحكم والثروة.
القضية الجنوبية:
ومن هذا المنطلق لابد من النظر بجدية إلى الأوضاع في الجنوب والتعامل معها على أن حراك المجتمع هناك مدفوعاً بقضية عادلة ذات دلالات عميقة في فهم مشكلة الحكم وسياساته الخاطئة قد وضع سؤالاً كبيراً وهاماً حول صمود الوحدة السياسية للبلاد في ظل هذه السياسات التي أساءت إلى الوحدة وفي ظل هذا النظام المركزي الذي تدار به البلاد وفي ظل هذه الروابط الرخوة للحوافز الوطنية الناشئة عن نظام الولاءات الذي حل محل الشراكة الوطنية. إن إحلال القوة والإدارة بالفساد كبديل للمشروع الوطني، ناهيك عن توجه السلطة نحو القضايا الخاصة في محاولتها لترميم الأوضاع هناك، إنما يعكس تحليلاً قاصراً لحقيقة المشكلة وطبيعة القضية التي يطرحها الناس تحت عنوان «القضية الجنوبية»، ذلك أن الاحتشاد السياسي والمعنوي في إطار هذه القضية إنما يعبر عن حاجة حقيقية لإصلاحات جذرية لمنظومة الحكم على النح، والذي يعيد بناءه على أساس شراكة حقيقية في الحكم وفي الثروة عبر بنى مؤسسية عصرية لامركزية تحقق هذا النوع من الشراكة. ولايمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه المطالب التي هي تعبير عن حاجة حقيقية للمجتمع هناك تضع هذا الجزء من الوطن في المكان الملائم كطرف في المعادلة الوطنية. إن المسارات التي تأخذها هذه القضية في ظل هذا الصمت المريب بل واللامبالاة من قبل السلطة والاكتفاء بالتلويح بالقوة مع إطلاق معالجات هشة وسطحية يجعلنا نؤكد على أن المشكلة تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي اعتبرناه جذر الأزمة الوطنية وما تمخض عنه من مظاهر بنيوية خطيرة كما شرحناها أعلاه.
وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على أن القضية الجنوبية يجب أن تكون من الأولويات التي يتم الحوار حولها بإشراك القوى الفاعلة في الحراك السياسي، مع أهمية وقف المطاردات والملاحقات للنشطاء السياسيين وتقديم من قاموا بالاعتداءات والقتل للمتظاهرين إلى العدالة، مع وقف محاكمة النشطاء السياسيين والعمل على تصفية آثار حرب 1994 دون التوقف، فيما يخص حقوق الناس وممتلكاتهم، عند الاشكالات السياسية.
قضية صعدة:
ولابد من النظر إلى صعدة والحروب المتكررة هناك باعتبارها انعكاساً لذلك المشكل البنيوي الخطير والمتمثل في غياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور وطني يتجاوز المفاهيم التي تستولدها ثقافة التفكيك في استجابة واضحة لضغوط المعطيات التي يفرزها غياب هذا النظام. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نهمل أهمية قيام الدولة الوطنية وبناء الشراكة على أسس عادلة وعلى قاعدة المواطنة المتساوية والتمسك بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الفكر التي كفلها الدستور. لايمكن أن نهمل كل ذلك في حل هذه المشكلة التي يخشى أن تمتد على أسس عرقية تستدعي من التاريخ تلك النزعة الجاهلية العمياء وذلك التعصب الاستعلائي الأحمق الذي حملته إلى الأمصار ثقافة بيئية مستبطنة في عقلية جلفة ظلت ترحل معها عبر الزمان والمكان حتى هذَّبها الإسلام مع الزمن، وكذا الحاجة إلى التعايش ثقافة المواطنة. ولايجوز لتلك العقلية أن يعاد إنتاجها اليوم على النحو الذي يصب في المجري العام لمواصلة إنتاج الأزمات في هذا البلد الذي لن يجد إستقراره إلا في الاعتراف بحق الآخر في الحياة والعيش الكريم.
وفي بهذا الصدد لابد أن يكون الحوثيون طرفاً في حوار وطني شامل من منطلق ما رتبته الوقائع من حقائق على الأرض وما خلفته تلك الحروب من دمار وآثار مأساوية، مادية ومعنوية، تتطلب معالجة شاملة بحيث لا تظل هذه القضية بينهم وبين السلطة فقط لأن الجميع معنيون بمستقبل هذا الوطن ومنه هذا الجزء الذي هو صعدة.
نهج العنف والتطرف:
وفي هذا السياق الذي يجري فيه الحديث عن جذر الأزمة يمكننا أن نلاحظ مظهراً آخر لهذه الأزمة يتمثل في تكريس مظاهر العنف والتطرف بل وقيام بعض الأجهزة برعايته. فالعنف بتعبيراته المتعددة يجد بيئة صالحة في السلوك المتطرف الذي ينتهجه النظام السياسي في إدارة البلاد بالاعتماد على التحريض المستمر للقوات المسلحة والأمن ضد المعارضة، وهو ما يشيع جواً من التحفز الدائم يجعل البلاد في حالة مواجهة مستمرة. ويلجأ النظام إلى هذا الأسلوب لفقدان جناحه السياسي القدرة على التأثير في الحياة السياسية بالأدوات السياسية والثقافة على الرغم من أنه يحوز على منظومة إعلامية ضخمة. غير أن هذه المنظومة مكرسة للتحريض وبث ثقافة الكراهية ومخصصة في الجزء الأكبر منها للهجوم الدائم والتحريض المستمر ضد اللقاء المشترك. وتتظافر كل هذه العوامل لتخلق مناخ العنف والتطرف، ناهيك عن أن الأوضاع الاجتماعية التي تتسع فيها مساحة الفقر وفقدان فرص العمل أمام الشباب بسبب سوء التخطيط والفساد الذي يسود قطاع العمل والخدمة، وتنامي مظاهر المحسوبية وبيع الوظيفة العامة وضعف الاستثمار الخاص والعام على السواء، كل هذا يجعل الشباب عرضة للتخبط، حيث يسهل في مثل هذه البيئة تسويق التطرف بأشكاله ونحله المختلفة، هو ما يلاحظ على نحو واسع في ظل تراجع العمل السياسي والتضييق الذي تمارسه السلطة على الأحزاب من خلال محاصرتها في الموارد المالية ومصادرة حقها في الساحة الإعلامية الحكومية وملاحقة أعضائها النشطاء وتسريحهم، في كثير من الأحيان، من العمل أو مضايقتهم وعدم السماح لهم بالترقي أسوة بغيرهم، ولجوئها أحياناً إلى إغرائهم بترك احزابهم إذا رغبوا في الترقية، وفي أحسن الأحوال شراء صمتهم مقابل الحصول على حسن السيرة والسلوك.
لقد تعرضت الحياة السياسية التعددية لضربات متلاحقة وبأشكال مختلفة من الممارسات التي تجعل الحياة الحزبية صعبة ومعقدة في نظر الكثير من الشباب، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن الالتحاق بالعمل السياسي الحزبي. ولذلك تتجه طاقات الشباب إلى ميادين أخرى، حيث تتشكل شخصياتهم بفعل تأثير عوامل وثقافات متطرفة تخاطب أوضاعهم المضطربة والصعبة وتتفق مع حاجتهم إلى توظيف طاقاتهم في الاتجاه المعبر بغضب، وربما بإنفلات، عن الأوضاع التي يعيشونها.
قضية المرأة:
والمرأة هي الأخرى يتم قمع نضالها من أجل حقوقها بأدوات يأتي في مقدمتها الحديث الخالي من المضمون عن مكانتها في المجتمع من قبل النظام في حين يمارس ضدها التمييز الواضح في التعيين في الوظائف العامة والمناصب القيادية، وهذا أهم دليل على أن النظام السياسي، جذر الأزمة، قد وضع المرأة داخل معادلة سياسية محكومة بقيود إجتماعية مقننة وذات دلالة خطيرة في التعاطي مع هذه القضية، وهي معادلة لايصعب فك رموزها، واتجه بصورة إنتهازية نحو أحزاب المعارضة لتسويق محنته الناشئة عن الالتزامات الدولية تجاه المرأة من ناحية وعدم قناعته الثقافية والسياسية على تحقيق هذه الإلتزامات من ناحية أخرى.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
وفي الوقت ذاته شكل نضوب النفط وفقاً لإدعاء السلطة على ذلك النحو السريع وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً للبلاد. وسرعان ما اتجه النظام إلى تحميل أعبائه الشعب من خلال رفع أسعار عدد من المواد والخدمات مثل الكهرباء، وتقليص مخصصات الحوافز والمكافآت وتقليص الوظائف الجديدة إلى الصفر، وتوجيه الاقتصاد نحو وضع انكماشي خطير سيعطل فرص الاستثمار ويخلق مناخات غير ملائمة للنشاط الاقتصادي، في حين أن الفساد الذي يستنزف جزءاً كبيراً من دخل وثروة البلاد هو الذي كان يجب أن تتوجه إليه السلطة في هذا الظرف لتصحيح الاختلالات المالية، إضافة إلى تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعبئة الموارد المالية والانتاجية على نحو أكفأ وأفضل، وتشجيع الاستثمار والبيئة الاستثمارية ومكافحة العوامل المعطلة للاستثمار وجذب الرأسمال الاجنبي وتحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التنمية ووقف تخصيص الموارد على نحو عشوائي خارج خطة التنمية والموازنة السنوية، وتطبيق نظام مالي ومحاسبي ورقابي على المؤسسات العامة والوحدات الانتاجية والادارية، ومنع الادارات التنفيذية في هذه الوحدات والمؤسسات من التصرف بالمال العام على ذلك النحو الذي يهدر المليارات في انفاق تَرَفي واختلاسات دون حسيب أو رقيب، وهو لا يحتاج إلى أى جهد لاكتشافه بل تكفي مظاهر الإثراء والترف الفاحش الذي يظهر به الكثير من هؤلاء بعد فترة وجيزة من تعيينهم.
إن هذه السياسة التي اتجهت فوراً إلى المجتمع لتحميله عبء هذه المصاعب تعكس انحياز النخبة الحاكمة والسلطة إلى الشريحة الاجتماعية التي أستأثرت بالنصيب الأكبر من ثروة البلاد وخاصة تلك الفئات التي أثرت ثراء فاحشاً بواسطة الفساد والمحسوبية، وهو الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات حقيقية من حيث المصاعب التي تولدها هذه السياسة من خلال خلق تفاعلات اجتماعية تصب في المجرى العام لثقافة الصراع والعنف الذي تولده سياسات هذه السلطة على كافة الأصعدة.
ويمكننا في هذا السياق أن نلاحظ أن الاستقطاب الاجتماعي قد أسفر بصورة عامة عن ثراء فاحش للقلة وفقر مدقع للغالبية الساحقة من الشعب، حتى أن الطبقة الوسطى التي يعول عليها في إحداث توازن اجتماعي يمنع التصادم بسبب اتساع الفجوة بين الغني والفقر، قد تقلصت إلى درجة لم تعد معها قادرة على أداء هذا الدور الاجتماعي، حيث أن الجزء الأكبر منها انحدر إلى مستوى خط الفقر وما دونه، وخاصة أصحاب الدخول الثابته. وهذه الظاهرة تجعل الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع ساحة لمواجهات اجتماعية خطيرة لاسيما وأن سياسات السلطة، كما أسلفنا، تتجه إلى تعميق المشكلة من خلال إتباع معالجات بتحميل الطبقات الفقيرة المزيد من الأعباء.
أما سياسات الأجور المتبعة في نطاق ماعرف بالاستراتيجية، فقد أثبتت أنها مجرد معالجات مسكنة لآلام الجرعات الكبيرة التي أفقرت الشعب، فالزيادة في الأجور لاتساوي أكثر من 15٪_ من الزيادة الحقيقية في كلفة المعيشة، الأمر الذي أدى إلى انحدار كثير من الفئات الاجتماعية إلى مادون خط الفقر، بما في ذلك أصحاب الانشطة الاقتصادية الصغيرة والفلاحين والعاملين في الزراعة الموسمية.
والأخطر من هذا هو أن الاقتصاد الطفيلي أخذ يزاحم الاقتصاد المنتج ويخرجه من الدورة الاقتصادية ويحل محله، بأخلاقه وقيمه وأدواته، وصار هذا النمط من الاقتصاد يهدد مستقبل البلاد الاقتصادي بإشاعة بيئة فاسدة طاردة للمستثمرين. فالاقتصاد الذي لايتوسع بالاستثمار في المجالات الانتاجية، على إختلاف أنواعها، يصاب بالركود والتضخم والبطالة، وهذا هو الوضع الذي يعيشه الاقتصاد اليمني في الوقت الراهن. إن الاستثمار اليمني يتدفق إلى الخارج، حيث الفرص متاحة، بما فيه أولئك الذين أثروا بالفساد. ولا يمكن أن تقنع المستثمر العربي والاجنبي أن يأتي إلى البلاد وهو يلمس عزوفاً يمنياً من الاستثمار في اليمن.
الديمقراطية ومنظمات
المجتمع المدني:
إن المعاناة التي تمر بها كافة فئات المجتمع كان لابد أن يجري التعبير عنها بواسطة النقابات والمنظمات المهنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي ينخرط فيها معظم هذه الفئات. غير أن الوضع الذي تعيشه النقابات وهذه المنظمات لم تعد معه قادرة على أداء هذا الدور بسبب الإهمال المتعمد والتدخل الفج للسلطة في شؤونها، وتحويل الكثير منها إلى مؤسسات حزبية أو حكومية تابعة للسلطة، وضرب نشاطها الحقيقي وتعطيل تمثيلها لمصالح الفئات المكونة لها، ما أفرز مناخات فساد وإفساد للكثير من القوى الحية التي يعول عليها في المشاركة في النهوض بالحياة الديمقراطية. وهذا الأمر عطل في الحقيقة أهم شروط التغيير الديمقراطي. إن قمع الحركة الجماهيرية بالإفساد لازال مستمراً كنهج خطير تريد السلطة بواسطته إستكمال حلقة السيطرة على المشروع الديمقراطي بهدف إخماد عناصره الجوهرية إلى الأبد. ويؤكد هذا التوجه أن منهج النظام السياسي الحاكم هو قمع الحياة السياسية الديمقراطية الحديثة ليتمكن من مواصلة استخدام أدواته التقليدية في إدارة البلاد بالأزمات والحروب والانقسامات.
الدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة:
وبهذا الصدد لابد من التذكير بالدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة منذ فجر ثورتي سبتمبر واكتوبر، وكيف أن هذه القوة الفاعلة في حماية الوطن ومكتسباته الثورية لابد أن يعاد إليها دورها ومكانتها من منطلق أنها قوة بيد الشعب قبل أن تكون أي شيء آخر، وهي معنية أكثر من غيرها بتجسيد هذه الحقيقة، عملاً لا قولاً. وبالتالي لابد من إعادة الإعتبار لها على هذه القاعدة وإعادة كل من تعرضوا للتسريح إلى أعمالهم بدون شروط، مع العمل على ترسيخ نظم وقواعد بنائها على أسس وطنية ومهنية، وتحسين الظروف المعيشية لأفرادها بما يليق ويتفق مع مكانتها ووظيفتها، واتباع نظام للترقي والقيادة يعيد لها هيبتها وشخصيتها كأحد أهم القوى المجسدة للشخصية الوطنية وهيبة الدولة.
إن القوات المسلحة والشرطة هي المعنية بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد، ولايجوز أستخدامها أو التلويح باستخدامها أو الاستقواء بها في العمل السياسي من قبل أي طرف، ذلك أن ما تمارسه السلطة اليوم بهذا الصدد والإصرار عليه إنما يحط من قدر القوات المسلحة والشرطة في تأدية وظيفتها الوطنية المتمثلة في حماية الدستور والقانون.
ويعكس هذا أزمة النظام السياسي الذي فقد الحيلة في طرح مشروع سياسي وطني لحل أزمة البلاد فأخذ يقحم القوات المسلحة والشرطة في الأزمة من خلال وضعها في الصدارة بتحريضها ضد المعارضة، وهذا ما يدعونا إلى التحذير من أن القوات المسلحة والشرطة هي حصان الرهان الوطني الذي لايجوز للسلطة أن تعبث به أو توظفه في مناوراتها السياسية والزج به في صراعات سياسية داخلية مكانها المؤسسات السياسية.
خلاصة:
هذا هو المناخ السياسي الاجتماعي الذي تريد هذه السلطة أن تمرر من خلاله انتخابات ذات نتائج معدة سلفاً فيما يعتبرها المشترك لو تمت على هذا النحو، وبصورة منفردة من قبل المؤتمر، اغتصاباً بالقوة لحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وإقصاءً للقوى السياسية بفعل إرادوي، وتراجعاً مقصوداً عن المشروع الديمقراطي تتحمل السلطة وحدها مسؤولية ما يترتب عليه من نتائج ومن آثار خطيرة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
من هذا المنطلق ترى أحزاب اللقاء المشترك أن معالجة الأزمة الوطنية والمشاكل المتفرعة عنها، يجب أن تتصدر الإهتمام والجهد الوطنيين على النحو الذي يعيد الاعتبار والثقة للديمقراطية والانتخابات عند الشعب، خاصة وأن كل المؤشرات تدل على أن هذه الثقة قد أخذت تتراجع على نحو خطير بسبب اليأس الذي اصاب الناس منها ومن قدرتها على إحداث التغير المطلوب إذا ما واصلت السلطة توظيفها لإعادة إنتاج نفسها، وإن تجاهل هذه الحقيقة لن يكون سوى بمثابة مغالطة للنفس لن تلبث أن تتكشف على حقائق مروعة تكون البلاد وفقاً لها قد غرقت في الكارثة.



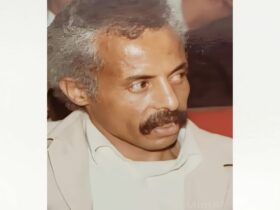


على شبكات التواصل